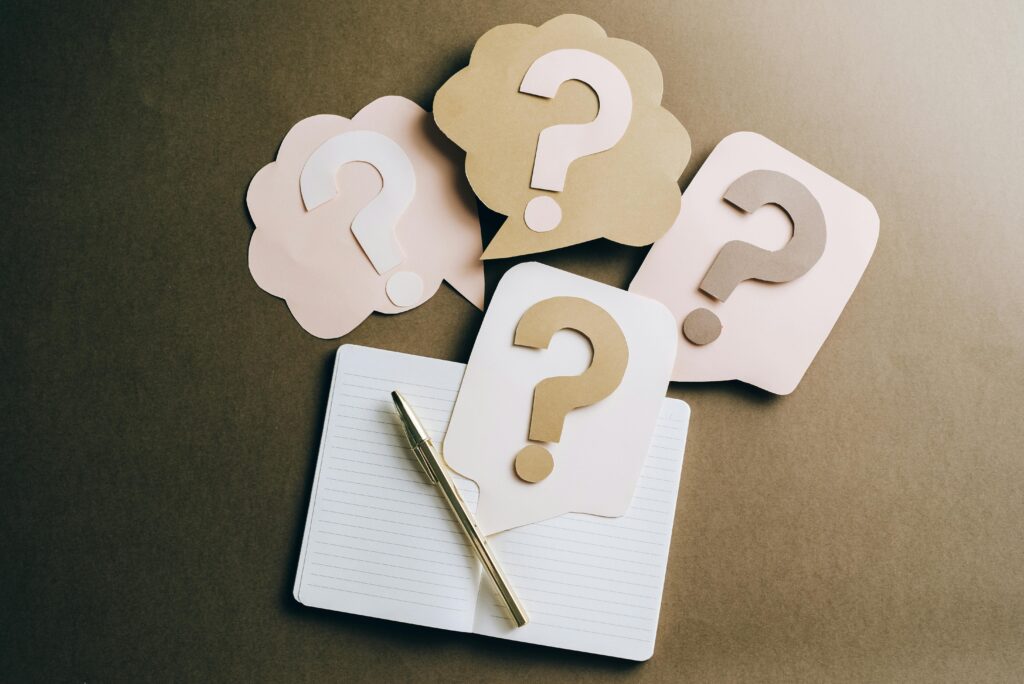نستطيع أن نقف على شيء من مفهوم الإبداع في اللغة من خلال النظر في قوله تعالى: (بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون). [البقرة:117] يقول الزجاج رحمه الله: (يعني أنشأهما على غير حذاء ولا مثال، وكلُّ من أنشأ ما لم يسبق إليه قيل له أبدعت)، فالإبداع إذن: صنعة الجديد، قال الراغب الأصفهاني: (معنى الإبداع هو إيجاد الشيء من العدم)، وقال أيضاً: (الإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء، ومنه قيل: رَكيَّةٌ بديع أي: جديدة الحَفْر).
وفي معجم المصطلحات التربوية والنفسية جاء تعريف الإبداع بأنه: (قدرة العقل على تكوين علاقات جديدة تحدث تغييرًا في الواقع. كما يعرف الإبداع من الوجهة السيكولوجية بأنه نوع من التفكير التباعدي، الذي هو نوع من التفكير الإنتاجي، وفيه ينتج الطالب حلولاً متنوعة متعددة للمشكلة الواحدة. وهو الذكاء المباعد والذي يؤدي للبحث عن أساليب جديدة والتوصل لحلول مبتكرة وعوالم مولدة، ويلجأ للخيال).
إن الإبداع وظيفة عقلية فيها تركيب وتعقيد، إذ لا بد للعقل الإبداعي أن يجتاز امتحان العقلية الناقدة، والتي تُعنى بالاستقراء والتحليل والفحص والتقييم، حتى تصح لديه المعطيات والمقدمات التي ينطلق منها إلى الفضاء الواسع والرحب للخيال والإبداع.
وعلى المؤسسة التربوية، سواء كانت بيتاً أو مدرسة أو محضناً تربوياً أو غير ذلك أن تبني القدرة على الخيال والإبداع في عقول الناشئة، ليكونوا أقوياء في عوالمهم الجديدة، قادرين على قيادتها، مؤثرين في ماجرياتها، متخطين لعقباتها، صانعي الحلول لمشكلاتها. إنها بذلك تكون قد حمتهم من الوقوع أسرى للمبدعين من الأمم الأخرى من مختلف الديانات والتوجهات، والذين ما فتئوا يُسخِّرون إبداعاتهم في التسلط على الأجيال الناشئة فكريًّا ومادِّيًّا.
ويمكن القول أننا في زمن المخترعات والإبداعات، والتي تصنع كل مدة واقعًا جديدًا يتطلب إمكانات عقلية ناقدة وإبداعية لمواكبته والدخول فيه بنفَس القائد والمؤثر.
وفي سياق تربية الناشئة فإن الأمر يتطلب عددًا من الوسائل والأساليب التي تبعث الإبداع في عقولهم، ومنها:
أولاً: النموذج الملهِم
المدرس المبدع يظهر انعكاس إبداعه في عقول الناشئة، والمدرسة التي تعتمد الإبداع أسلوب تفكير لإنتاج البرامج والحلول هي في الحقيقة تربي الطلاب على الإبداع، والابن الذي يشاهد الجمال والإبداع في بيته تُبذَر في عقليته بذور الإبداع، ويلعب (مربي الصف أو المعلم دورًا وسيطًا إيجابيًّا، بين المدرسة والأسرة، حيث ينقل للأسرة مدى إبداع ولدهم في جانب معين أو عدة جوانب متعددة، وذلك على أمل التواصل والاستمرارية والدعم والمتابعة، والمعلم ينقل أيضاً لإدارة المدرسة إبداع طلابه، ويوفر لهم الدعم المادي من ميزانية المدرسة والدعم المعنوي والتعزيز المناسب).
فمن الأهمية بمكان أن تنشأ الأجيال الجديدة وهي تشهد نتاج العقول الإبداعية في مجتمعها، وتنظر إلى الاحتفاء بهذه المشاهد، حتى يصبح التفكير الإبداعي في مفهومها: نمط صحي للحياة.
ثانياً: تنمية الخيال:
إذا قلنا إن الحضارة الغربية قامت – بإذن الله – على التفكير التجريبي، فإن الخيال كان أحد العناصر الرئيسية الحاضرة في اختراع الحلول، ومن هنا ظهرت المخترعات، ويوصف القرن التاسع عشر بأنه قرن المخترعات، حيث اختُرع فيه الكثير من الأشياء التي تستخدم اليوم في عالمنا بشكل مألوف، كالقطارات والمحركات والإضاءة الكهربائية والتصوير الفوتوغرافي والبطارية الكهربائية والهاتف وماكينة الخياطة والسلالم المتحركة والمصعد وسيارات البنزين، وغيرها الكثير، وإذا كان هذا في القرن التاسع عشر فكيف بالقرن العشرين الذي اخترع فيه الإنترنت والطائرات والصواريخ!
والمقصود أن هذه المخترعات بنيت في كثير من الأحوال على الخيال، والتفكير المفتوح الذي لا يرفض الحلول قبل تجريبها، ومحاولة خلق الجديد غير المألوف، وجعل المتخيل هدفًا ومنتجًا.
ثالثًا: تحفيز الإبداع:
سيجد الطلاب أنفسهم مدفوعين نحو الإبداع، وسيجدون عقولهم منفتحة على الخيارات الغامضة والمستبعدة حين تكون البيئة التربوية محفزة للإبداع.
وتكون البيئة التربوية محفزة إذا كانت آمنة وحرة، فإذا كانت البيئة التربوية بيئة آمنة للانطلاق والإبداع والابتكار وتنمية الموهبة الخاصة للفرد فسيكون ذلك فرصة له لشق طريقه الخاص الذي ينفع به أمته من خلال إيجاد الحلول الإبداعية وابتكار الأفكار الخلاقة.
إننا حين نستعيض عن اللوم بالحوار وعن العقاب بالتوجيه ستتحول البيئة التربوية إلى مصانع للمبدعين.
وإذا توافر مناخ آمن لتجريب القدرات والذكاءات والإبداعات، كان ذلك حافزًا نحو الإبداع، إذ تعمل القيود الكثيرة والتنبيهات الدقيقة على القلق وتفضيل خيارات السلبية والجمود والتبعية. وتمثل فكرة “براءة الاختراع” أسلوبًا تحفيزيًّا للإبداع يستحق النظر إليه باعتباره نموذجًا جيدًا يمكن استلهام فكرته في صناعة نماذج تحفيزية للإبداع، وكان عمر بن الخطاب يستشير ابن عباس في الأمر إذا أهمَّه ويقول: غُصْ غواص. والغواص هو الرجل الذي يدخل البحر إلى قاعه ليستخرج اللؤلؤ والصدف، فهو يعلم أن ابن عباس لديه القدرة على الإبداع والاستنباط واستنتاج الحلول.
وبعض البيئات التربوية يتملكها الخوف من تجريب الجديد وخوض غمار المبتكرات لأشياء ظنية، وهذا يجعل الطلاب يحجمون عن السير في طريق الإبداع.
رابعًا: إتاحة الأسئلة
ينبغي أن يضمَّن التعليم الحوارَ، الحوار الذي يتيح الأسئلة ويولِّدها، ويصنع الإجابات المفتوحة، ويطرح الأسئلة الاحتمالية: ماذا لو كذا وكذا لما هو غير مألوف في الحياة الواقعية القريبة. وواجب المؤسسة التربوية أن تربِّي الناشئة على ذلك، لما فيه من النماء العلمي والفكري، قال الزهري: (العلم خزائن ومفاتيحها السؤال). ولذلك أُثر عن حبر هذه الأمة ابن عباس قوله: (إنْ كنتُ لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب النبي ).
ويدخل في هذا الباب صناعة المواد والمقررات والوسائط التي تبعث الأسئلة.
خامسًا: التدريب على التفكير الإيجابي
صاحب التفكير الإيجابي هو الذي لا يقف أمام التحديات مكتوف اليدين، ولا يتعامل معها بجبرية، وإنما يتخذ القرار ويقيِّم الموقف ويكون متفائلًا ويستعين بالله تعالى قبل كل شيء.
والتفاؤل ليس مجرَّد شعور قلبي وإنما هو فوق ذلك نمطٌ من أنماط التفكير حثَّ عليه نبينا واستعمله، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : (وأحب الفأل الصالح). قال البغوي: (وإنما أحب النبي الفأل لأنَّ فيه رجاء الخير والعائدة، ورجاء الخير أحسن بالإنسان من اليأس وقطع الرجاء عن الخير). فهو حديث داخلي ينتج عن حسن الظن بالله والعلم بقدرته الكاملة ورحمته الشاملة ومعيته للمؤمنين، قال الحليمي: (وإنما كان يعجبه الفأل لأنَّ التشاؤم سوء ظنٍّ بالله تعالى بغير سببٍ محقَّقٍ، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمورٌ بحسن الظن بالله تعالى على كل حال).
ولذلك تجد سير الأنبياء والمصلحين والمجددين حافلة بالشعور الإيجابي رغم شدة الأهوال التي يواجهونها والمخاطر التي تحدق بهم، وما ذاك إلا لحسن ظنهم بالله وعلمهم بأسمائه وصفاته وسننه في الكون والحياة ومعرفتهم بطبائع الأشياء وتاريخ المبدعين.
والمقصود أن المبدعين لا تهزمهم التحديات، ويرون في المضائق فرصًا مهمة. ويقع على المؤسسة التربوية تعويد الطلاب على هذا النمط من التفكير، وتدريبهم على تجاوز التحديات بفأل وحسن ظن بالله.
والتفكير الإيجابي يسبقه النظرة الإيجابية للذات والثقة بالنفس، وهذا ما يتوجب العمل عليه داخل نطاق التربية والتعليم، فإن حديث النفس من داخلها ينعكس على خارجها، وليس هذا الغرور ولا الكبر، وإنما هو معرفة الإنسان بالطاقات والقدرات التي أعطاه الله إياها ليسخرها في تقديم المفيد والنافع.
وأخيراً؛ ليس كل الناشئة مبدعين وأذكياء، لكنه ينبغي ألا تهمل شريحة المبدعين من الاهتمام والاعتناء.